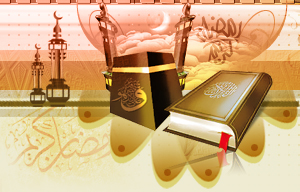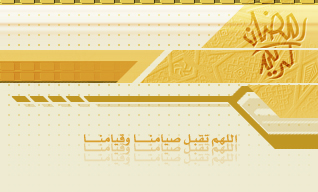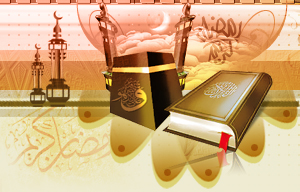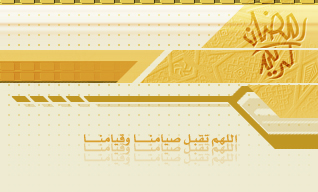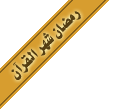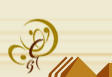سوء الظن بالآخرين
*سوء الظنّ إنّ ممّا يُبتلى به النّاس بكثرةٍ على مرّ العصور سوءُ الظنِّ ببعضهم البعض، حتّى كاد ذلك أنْ يُذهِب علاقاتهم الاجتماعيّة، ويُقطّع أواصر المَحبّة، ويُفشي السّوء والبغضاء بينهم، ولقد حثّ الله عزّ وجل على اجتناب سوء الظنّ بالآخرين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾.
مفهوم سوء الظن
*بالإمكان تعريفُ سوء الظنِّ بأنّه مَظنّة جانب الشرّ وتغليبه على جانب الخير، في حين أنّ الموضوع الذي وقع فيه سوء الظنّ قد يَحتمل الجانبين معاً دون تغليبٍ لأحدهما، قال الماوردي: (سوء الظنّ هو عدم الثّقة بمن هو لها أهل)، وقال ابن القيم: (سوء الظن هو امتلاء القلب بالظّنون السّيئة بالنّاس حتى يطفح على اللسان والجوارح)، وقال ابن كثير: (سوء الظنّ هو التّهمة والتخوّن للأهل والأقارب والنّاس في غير مَحلِّه).
*كما يُمكن أن يُعرّف سوء الظنّ أيضاً بأنّه الخوض في الخيال المُسيء والخطأ في حالة مُواجهة فعلٍ يُمكن أن يكون له تفسيرين، صحيح وخاطئ؛ كمن رأى رجلاً مع امرأةٍ غريبة فخاض في خياله دون تبيُّن، وحلّل أنّ المرأة أجنبيّة عن الرّجل وليست من محارمه، وبدأ في التخيّل أنّ هذا الرّجل يُريد لها السّوء وارتكاب الفاحشة معها، بينما ربّى الإسلام أبناءه على إحسان الظنّ؛ فربما تكون على قرابة معه كأخته أو عمّته أو زوجته.
رُوِيَ أنّه لمّا نظر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلى الكعبة قال: (مرحباً بك من بيت ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك، ولَلْمؤمن أعظم حُرْمَة عند الله منكِ، إنَّ الله حرَّم منكِ واحدة، وحرَّم من المُؤمن ثلاثاً: دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ السَّوء).
سوء الظنّ في القرآن الكريم
*لقد تحدّثت آيات كريمة عدّة عن هذا المرض الأخلاقيّ الذي مزّق المجتمعات، ومنها: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾، وتتحدّث هذه الآية عن سوء الظنّ الذي يتعلّق بالربوبيّة والمُقدّسات الإلهية؛ فتُبيّن أنّ سوء الظنّ الواقع من هؤلاء النّاس هو أنّهم يتّهمون الله في خلقه وحكمه، ويظنون السّوء بالرّسول عليه الصّلاة والسّلام وصحابته. وممّا لا شكّ فيه أنّ سوء الظنّ بالله تعالى يختلف اختلافاً كُليّاً عن سوء الظنّ بالآخرين؛ لأنّ سوء الظنّ بالآخرين سينتهي غالباً بالوقوع في الإثم أو التصرّف بشكل خاطئ مع الطّرف الآخر، بينما سوء الظنّ بالله تعالى يُؤدّي إلى اهتزاز ركائزَ الإيمان وأركان التّوحيد في قلب المؤمن، أو على الأقل سيكون دافعاً ومُحفّزاً لذلك؛ لأنّ الظنّ بأنّ الله تعالى قد يُخلِف وعده لهو واقع في دائرة الكفر، فإخلاف الوعد ينشأ إمّا من الجهل، أو عن عجز، أو عن كذب، وتعالى الله عن هذه الصّفات.
﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾، يقول تعالى للأعراب المُعتذِرين إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عند مُنصَرَفِه يوم فتح مكة إذ قالوا: (شغلتنا أموالنا وأهلونا)، ما تخلّفتم خلاف رسول الله عليه الصّلاة والسّلام وقعدتم عن صحبته من أجل شغلكم بأموالكم وأهليكم، بل تخلّفتم بعده في منازلكم ظنّاً منكم أنّ رسول الله ومن معه من أصحابه سيهلكون فلا يرجعون إليكم أبداً باستئصال العدو إيّاهم، وزيّن الشّيطان ذلك في قلوبكم وحسّنه، وصحّحه عندكم حتى حَسُن عندكم التخلّف عنه، فقعدتم عن صحبته (وظننتم ظنّ السّوء). يقول: وظننتم أنّ الله لن ينصر مُحمداً - عليه الصّلاة والسّلام - وأصحابه المُؤمنين على أعدائهم، وأنّ العدو سيقهرهم ويغلبهم فيُقتَلوا. ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾، يؤكّد الله تعالى في هذه الآية أنّ الظنّ لا يُجدي شيئاً، ولا يقوم أبداً مقام الحق.
*سوء الظنّ في السنّة النبويّة
تحدّث الرّسول محمد -عليه الصّلاة والسّلام- في كثير من الأحاديث عن هذه الآفة المُجتمعيّة، منها الآتي: عن النَّبي عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: (إيَّاكم والظَّن، فإنَّ الظَّن أكذب الحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانًا). قال النَّووي: (المراد: النَّهي عن ظنِّ السَّوء)، قال الخطَّابي: (هو تحقيق الظَّن وتصديقه دون ما يهجس في النَّفس، فإنَّ ذلك لا يُمْلَك. ومراد الخطَّابي أنَّ المحَرَّم من الظَّن ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر في قلبه، دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإنَّ هذا لا يكلَّف به).
منقول