 |
 |
 |
| روائع شعريه |
| روائع الكسرات |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
 |
 |
 |
| روائع شعريه |
| روائع الكسرات |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
#1 |
|
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ...)
ثم قال جل شأنه: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور:23]. للعلماء في هذه الآية قولان: الأول: أنها عامة في كل قاذف، وهذا قول الجمهور، وهو الأظهر. فإذا قلنا بأنها عامة في كل قاذف فإن معنى اللعن هنا إقامة حد القذف عليهم، فيصبح معنى اللعن هنا إقامة حد القذف عليهم. والقول الآخر: الذي قاله بعض العلماء هو أن الآية في عائشة وأمهات المؤمنين، وأن المخاطبين بهذا الآية هم المنافقون، فقالوا: لعنهم في الدنيا بطردهم من رحمة الله، ولعنهم في الآخرة بعذاب النار. فجعلوا هذه الآية خاصة فيمن قذف أمهات المؤمنين، ولذلك قالوا: لم يذكر الله جل وعلا بعدها توبة، فكون الله لم يذكر بعدها توبة قرينة تؤيد قول من قال: إنها في أمهات المؤمنين، ومن قال إنها عامة فلكون هذا هو الأصل في الخطاب الشرعي. |
|

|
|
|
#2 |
|
حكم لعن المعين
وهنا مسألة تتعلق باللعن اختلف الناس فيها كثيراً، وهي لعن المعين، وأرجح الأقوال ما قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى وحرره، وهو قول جيد لمن تدبره، وهو أن اللعن إذا أريد به الدعاء وإخراج الإنسان من رحمة الله فهذا لا يقع على معين، إلا على كافر مات على كفره، أما إذا أريد به شدة النكال وشدة التضييق عليه فإنه يجوز. ومثال ذلك في رجل آذى المسلمين كثيراً في العصر الحاضر كـشارون ، فـشارون لم يمت بعد، فإذا أردت بلعنه التشديد عليه والتضييق وشدة النكال فذلك جائز، وإذا أردت أن تدعو بألا يرحمه الله -بمعنى أنه يموت على الكفر- فذلك لا يجوز؛ لأنه ليس لأحد أن يذهب ليحدد جهة وقوع رحمة الله. وهذا القول من ابن حجر قول محرر يحل إشكالاً قائماً في القضية، فجزاه الله خيراً وعفا الله تبارك وتعالى عنا وعنه. ثم قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النور:23-24]. وهذا يكون يوم القيامة، وقد حررنا له قرائن كثيرة. |
|

|
|
|
#3 |
|
تفسير قوله تعالى: (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ...)
ثم يقول تعالى: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ [النور:25]. ومحال أن يكون دين الكفار حقاً، فكلمة (دين) هنا معناها: الجزاء، فيصبح المعنى: يومئذ يوفيهم الله جزائهم الحق، وكيف يكون جزاؤهم حقاً؟ إن معاقبة المسيء على إساءته هي عين الحق، كما أن الإحسان إلى المحسن لإحسانه كذلك هو عين عين الحق. ثم يقول تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [النور:26]. وللعلماء فيها قولان: قول يقول: إنها في الأقوال. وقول يقول: إنها في المشاكلة. ومعنى أنها في الأقوال أن الخبيثات من الأقوال تليق بالخبيثين والخبيثات من الرجال، والطيبات من الجمل المادحة المعبرة تعبيراً حسناً تليق بالطيبين من الرجال والطيبات من النساء، وهذا قول الجمهور. وقال آخرون: إن من سنن الله الإلهية الملاءمة بين كل متفق، فالخبيثات من النساء لا يلائمهن إلا الخبيثون من الرجال، والخبيث من الرجال لا تلائمه إلا الخبيثة من النساء، والطيبات من النساء لا يلائمهن إلا الطيبون من الرجال، والطيب من الرجال لا تلائمه إلا الطيبة من النساء. وهذا المعنى عندي أقرب، ولكن يرد إشكال عند الناس منعهم من هذا القول، حيث يقولون: إنك ترى الآن امرأة صالحة صوامة قوامة محسنة إلى أولادها، وزوجها فيه من الخبث والشرور ما الله به عليم، بل ربما يتاجر في المخدرات، ويسعى في المسكرات، فيكف تقول: الطيبات للطيبين بهذا المعنى؟ ونقول: يجب أن تفرق، وإلا فهذا القول فيه نوع من المجازفة؛ لأني لا أعلم أحداً نص بهذا التعبير، فينبغي أن يفرق بين حياة المعايشة وحياة الملائمة، فالزوجات الطيبات الصالحات المقترنات بأزواج مرتكبين للكبائر لا يكون هناك تلائم روحي بينهم، وإنما المرأة هنا صابرة من أجل بنيها، أو تحتسب تغيير زوجها. وإذا كان الرجل هو الطيب والمرأة هي السيئة فإنه يمنعه من طلاقها خوفه على أبنائه، ولا توجد ملائمة روحية. أما ما كان ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فقد كان تآلفاً جماً وتلاؤماً تاماً، ومحبة قائمة بين الطرفين، ولهذا قيل له: من أحب الناس إليك فقال: عائشة فهذا الأمر يستبعد الإشكال القائم على أن الذي منعهم هو أن الواقع -وهو أعظم الشهود كما يقولون- يمنع أن يكون المعنى التلائم، وقلنا: يفرق بين التعايش وبين التلائم، وقد قال المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد |
|

|
|
|
#4 |
|
فضيلة قول: (حسبنا الله ونعم الوكيل)
وهنا فائدة عظيمة، وهي ما قالته عائشة عندما ركبت، وهو أمر لا يحتاج إلى أن تجربه. يقولون: إن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تنافس عائشة ، وأحياناً يحصل بينهما تفاخر محمود، وعندما يحصل بين أمهات المؤمنين تحاور ينجم عن ذلك علم، فقد نشأن في بيت النبوة، فقالت زينب : أنا التي أنزل الله تزويجي من فوق سبع سماوات. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأنا الذي أنزل الله براءتي لما حملني صفوان بن المعطل على راحلته. وهنا نسيت زينب المحاورة، فقالت: يا عائشة ! ما قلت عندما ركبت الراحلة؟ فقالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تجربة، فوالله الذي لا إله غيره إن هذه الكلمة تهد الجبال، فإذا أغلق عليك أمر فلن تجد مثل: (حسبنا الله ونعم الوكيل). وأنا أعرف رجلاً صالحاً كان عنده طالب علم، فكان دائماً يوصيه بـ (حسبنا الله ونعم الوكيل)، وفي ذات يوم استقل الطالب هذه الكلمة، فعاتبه قائلاً: يا بني! (حسبنا الله ونعم الوكيل) تهد الجبال. فكل واحد منا إذا وقع في معضلة أو رأى شيئاً أقبل عليه مما لا يطاق، فليعتصم بقول (حسبي الله ونعم الوكيل)، فإنه لن يكفيك أحد مثل الله، ولا وكيل بعد الله، جعلنا الله وإياكم ممن توكل عليه فكفاه، واستهدى به فهداه. فهذا ما تيسر إيراده وأعان الله على إملائه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. |
|

|
|
|
#5 |
|
من جملة أحكام سورة النور العظيمة إرشاد الله تعالى عباده وتأديبه لهم وذلك ببيان آداب دخول بيوت الآخرين، فقد بين تعالى ما يجب على الداخل فعله، وما يفعله من لم يُجب عند استئذانه، وما يحل دخوله بغير إذن من البيوت. كما أن من جملة أحكامها أمر الله تعالى عباده المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، وحفظ الفروج، وخص تعالى المؤمنات بنهيه لهن عند إبداء الزينة لغير الزوج والمحارم، ولعلمه تعالى بقصور عباده -وإن امتثلوا- أمرهم بالتوبة صقلاً لقلبوهم وتحصيلاً لمغفرة ربهم.
|
|

|
|
|
#6 |
|
بيان صلة آداب دخول البيوت بالكلام عن الزنا وأحكام القذف
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في سورة النور، وقد بينا من قبل أنها سورة قد جمعت أحكاماً وآداباً، وكان الصحابة -كما هو المنقول عن عمر وعائشة - يوصون الناس بتلاوتها وتدبرها، وقد مضى الحديث في الدروس الأولى أكثر ما كان يتعلق بقضية فاحشة الزنا، فذكر الله جل وعلا أحكام فاعليها ومآلهم وحد القذف، ثم ذكر الله بعد ذلك براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ناسب الكلام عن الزنا والفواحش أن يكون بعده آداب تبين للمؤمنين الطرائق المثلى للنجاة من تلك الفواحش، والقرآن مفزع أهل الملة يلجئون إليه؛ لأن الله جل وعلا جعل فيه خبر الغابرين وأنباء السابقين، وأحكاماً أنزلها على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلما كان الزنا بريده الخلوات والنظر والاطلاع على العورات، ناسب بعد ذلك أن يبين الله جل وعلا الطرائق المثلى والسبل العليا في غض البصر وحفظ الفرج وسلامة البيوت وستر العورات؛ حتى يكون المؤمنون على بصيرة من أمرهم. والرب جل وعلا يقول في كتابه العظيم: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا [البقرة:26]، ومن أراد أن يبين للناس الحق ويدلهم على الرشد فإنه لا يستحيي من أمر دون آخر، وإنما يكشف الأمور بجلاء، وكذلك القرآن تنزيل رب العالمين جل جلاله، فقد يقول قائل: كيف يتكلم الله عن العورات، وكيف يتكلم الله عن البيوت، وكيف يتكلم الله عن المحيض؟! والجواب أن هذا الكتاب جعله الله جل وعلا هدى بين فيه للناس ما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم. ولما كان يوم القيامة يوم حساب ويوماً تعرض الأعمال فيه على الله كان حقاً على الله من قبل ذلك -ولا ملزم لله- أن يبين لخلقه كل أمر؛ حتى يكون الحساب على ذلك، قال الله جل وعلا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ [التوبة:115]. |
|

|
|
|
#7 |
|
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ...)
كرامة المؤمن على الله والآية التي نحن بصددها هنا هي قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:27]. فالياء حرف نداء، والمنادى هم الذين آمنوا، والنداء بـ (الذين آمنوا) يسمى نداء كرامة، في حين أن النداء بقوله: (يا أيها الناس) أو: (يا بني آدم) نداء علامة بحسب ما اتصفوا به، فـ (يا أيها الذين آمنوا) نداء كرامة، والمؤمن كريم على الله. ومن أعظم الدلائل على أن المؤمن كريم على الله ما روي من أن خلف بن عمرو قرأ على أحد الصالحين القرآن، فلما وصل إلى قول الله جل وعلا: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا [غافر:7] بكى الرجل الذي كان يقرأ عليه القرآن، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: يا خلف ! انظر كرامة المؤمن عند الله، نائم على فراشه وتستغفر له حملة العرش! |
|

|
|
|
#8 |
|
المراد بإضافة البيوت في قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم)
قوله تعالى: لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ [النور:27] الملكية هنا ليست مراده، فقوله تعالى: (غير بيوتكم) أي: غير التي تسكنون، وهذا واقع في هذا العصر، فإضافة البيت هنا ليست إضافة تمليك، والمقصود البيت الذي تسكنه، فالبيت الذي تملكه إذا أجرته من غيرك فسكنه فإنه لا يعتبر في عرف الآية ودلالتها بيتاً لك، فالله يخاطبك فينهاك عن البيوت التي لا تسكنها، بصرف النظر عن تملكها، وكونك في بيت ملك أو في بيت مستأجر، فالعبرة هنا بالسكنى. |
|

|
|
|
#9 |
|
بيان المراد بالاستئناس
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا [النور:27] (حتى) تأتي لابتداء الغاية، وتأتي لانتهاء الغاية، وقد قال أحد النحاة: أموت وفي نفسي شيء من (حتى)، وأظنه أبا عمرو بن العلاء ، فقد درس النحو وتعمق فيه، وكان من الأقدمين من شيعة سيبويه الأولين، يقول: أموت وفي نفسي شيء من (حتى)؛ لأن ما بعدها يصلح له كل شيء، فلم يستبن له الأمر فيها. فـ(حتى) هنا لانتهاء الغاية أو لابتدائها، وهذا كله يظهر حسب سياق القرآن. فقوله تعالى: لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور:27] هذا أدب رباني يعلم الله فيه المؤمنين، ولكن الإشكال قائم عند العلماء في معنى الاستئناس، فالسلام معروف، واختلفوا في الاستئناس، فقال قوم: الاستئناس هو الاستئذان نفسه. وقال آخرون: إن الاستئناس أن تحدث صوتاً قبل أن تستأذن، كأن تتنحنح أو ترفع من صوت سيارتك إذا قربت، أو تغلق بابها بقوة لتشعر أن هناك رجلاً قادماً. والعلماء يقولون: إن الاستئذان ثلاث مرات: فالمرة الأولى حتى لينصت أهل الدار، والمرة الثانية ليستصلحوا، ويغيروا في أثاث البيت، والمرة الثالثة ليأذنوا أو ليقولوا لك: ارجع. وبعض العلماء يقول: إن الاستئناس لا هذا ولا ذاك، وإنما هو ضد الاستيحاش، والاستيحاش: الوحشة، والقادم على أي دار يجد في نفسه وحشة وغربة، فهل سيقبله أهلها أم لا، فإذا قبل زالت عنه تلك الوحشة، ولذلك كان حرياً بمن يستقبل أن يقول: مرحباً أهلاً وسهلاً، فغربتك تشفى بكلمة (أهلاً)، أي: وجدت لك أهلاً يذهبون عنك الوحشة، فهذا هو الذي دفع أقواماً إلى أن يقولوا: إن الاستئناس هو من الأنس وإبعاد الوحشة. يعني: لابد أن يتبين لك أن أهل الدار راغبون في استقبالك أو غير راغبين، فإن فهمت منهم -ولو أذنوا- أنهم غير راغبين؛ فالأولى والأحرى أن تنصرف. وهذه المعاني لم تتعرض لها الآية، ولكنها استنباطات العلماء، وفرق بين النص وبين تعليق العلماء على النص، فالتقديس يذهب إلى النص، وعدم التقديس يذهب إلى غير النص. نقول: ويدل على أن معنى الاستئناس ما ذكره قول الله جل وعلا: آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا [القصص:29]؛ فإن موسى عليه السلام كان في حالة وحشة، فلما رأى النار ورأى النور زالت تلك الوحشة، كإنسان غريب ضائع تائه في صحراء مظلمة يخشى ويستوحش، فحين يرى عن بعد شيئاً ما تزول عنه تلك الوحشة تدريجياً. قال تعالى: حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور:27] أي: أهل الدار، وقد قلنا: إن الاستئذان قد دلت السنة على أنه ثلاث، كما في حديث عمر لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في تلك المشربة، فإنه بعث عبداً يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فرده مرتين فلم يجب وفي الثالثة قبله. قال تعالى: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:27]. أي: هذا التشريع الرباني والنص الإلهي والأدب القرآني خير لكم، ولابد من أن يكون فيه خير؛ لأنه من عند الله، والتذكر والتبصر لا يكون إلا بتعاليم الكتاب وتعاليم السنة. |
|

|
|
|
#10 |
|
ذكر قصة عمر في الاستئناس
وتذكر في هذا الباب قصة عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الاستئناس والاستئذان، وذلك عمر رضي الله تعالى عنه مر على حائط فيه فتية من الأنصار يشربون الخمر، فتسور الحائط بعد أن تبين له أن هناك سكارى خلفه، فداهمهم وأنكر عليهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين! قد جئنا بواحدة -وهي شرب الخمر- وجئتنا بثلاث: وهي أنك تجسست، والله قد نهى عنه، وقال الله تعالى: حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا [النور:27] ولم تستأنس، وقال: وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا [البقرة:189] وأنت تسورت علينا الحائط، فرجع عنهم وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر . وقد قيل: إن عمر رضي الله تعالى عنه قبل قولهم من باب أنهم استندوا إلى القرآن، ومن علامة التقوى أن يقبل الإنسان الأمر الرباني ولو جاء من أقل منه، وقد قال حافظ رحمه الله تعالى يصور هذا الموقف: وفتية أولعوا بالراح فانتبذوا لهم مكاناً وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم لما عَلِمَت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأتِ البيوت من الأبواب يا عمر فقد يُزَّنُّ من الحيطان آتيها ولا تجسس فهذي الآيُ قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها فما دام أن من يخاطبك ويجادلك يخاطبك بهذا النور المبين فإنه يجب عليه أن تقبله، ولو كان هو لا يعمل به؛ لأنه قد أقام الحجة إليك ودعاك بهذا القرآن. وهذه القصيدة تسمى بالعمرية، وهي موجودة في ديوان حافظ في أكثر من مائتي بيت، كنا نحفظها في زمن الصبا وقد قسمها حافظ باعتبارات جملة أحداث، فقد قال في قصة نصر بن حجاج ، الذي كان وسيماً فنفاه عمر إلى الكوفة أو إلى البصرة: جنا الجمال على نصر فغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها ثم ذكر الأبيات. وذكر قضية رسول كسرى حين قدم على عمر فقال في أولها: وراع صاحب كسرى أن رأى عمراً بين الرعية عطلاً وهو راعيها ثم لما قال صاحب كسرى : حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ، قال حافظ : أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها وفي تاريخ عمر عزله لـخالد ، فقال: سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنت تواليها وذكر عمر وجوعه في عام الرمادة، فقال: يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغررك من دنياك مغريها وقد استطردنا في هذا وإن كنا في كتاب التفسير، ولكن المنهج في تعليمنا للناس هو أننا نفرع كثيراً؛ حتى نبين أن جماع التفسير هو العلم بشتى الفنون، فذلك يقودك إلى أن تكون إماماً في التفسير، وأما من كان معتمداً على فن واحد دون سواه فقل ما يستطيع أن يجري في مضمار علم التفسير؛ لأنه إذا كان القرآن أم العلوم كلها فلابد من أن يكون القائم به مطلعاً على شتى الفنون، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: بل السنة كلها في آية واحدة: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]. |
|

|
 |
|
|
|
|
 |
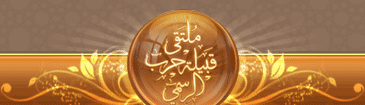 |
 |